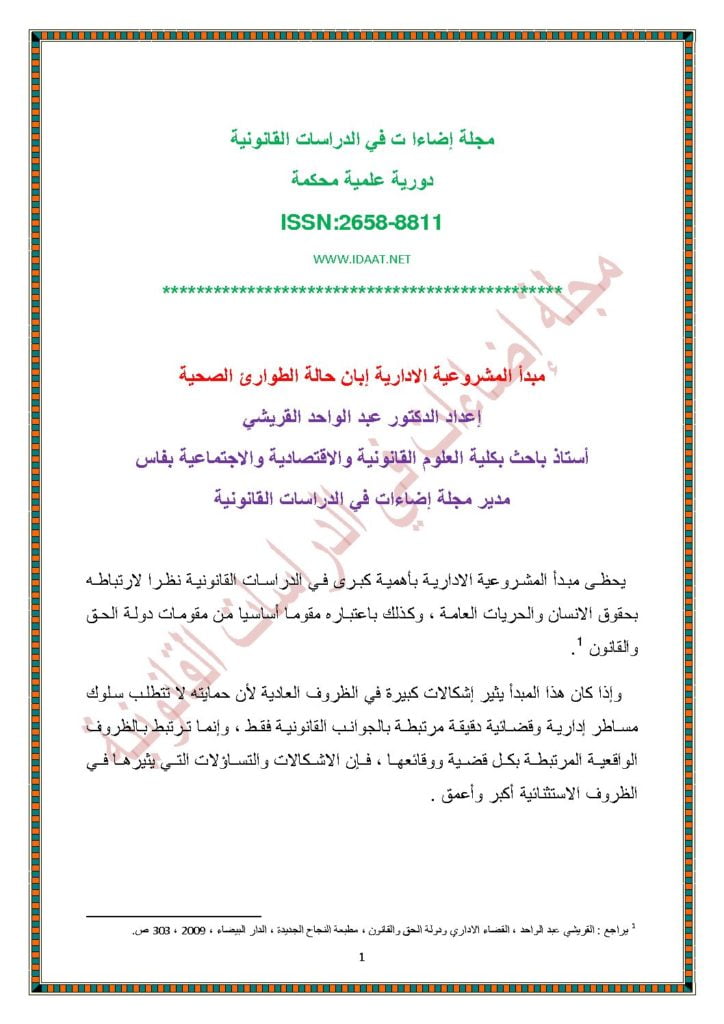تجليات الأمن القضائي في مشروع قانون التنظيم القضائي
تجليات الأمن القضائي في مشروع قانون التنظيم القضائي اهتمت العديد من الخطب الملكية بإصلاح القضاء ، ومنذ فجر الاستقلال تعددت المبادرات الاصلاحية ، ولم تشمل هذه المبادرات جهاز القضاء فقط ، بل اهتمت بالمهن القضائية والنصوص القانونية . ومن أهم المبادرات الإصلاحية في هذا الشأن نجد الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي تم بمقاربة تشاركية وبتدخل مختلف شرائح المجتمع ، وقد خلص الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إلى ميثاق وطني تضمن العديد من التوصيات التي تروم الرقي بمستوى العدالة ببلادنا. وتبعا لذلك فقد شكل تعديل القوانين الأساسية المتعلقة بجهاز القضاء أحد المحاور الاساسية التي انكبت على إصلاحها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، وهكذا عرض على البرلمان النظام الأساسي للقضاة ،القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية …،كما صادق المجلس الحكومي مؤخرا على مشروع قانون التنظيم القضائي [1] إصلاح منظومة العدالة يتلاءم ودستور 2011 والذي عزز مكانة السلطة القضائية وأولاها مهاما جسيمة أهمها ما نص عليه الفصل 117 والذي جاء فيه : << يتولى القاضي حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي ، وتطبيق القانون >> مفهوم الأمن القضائي تم التأكيد عليه في المادة 34 من مشروع قانون التنظيم القضائي التي نصت على أنه :<< يمارس القضاة مهامهم باستقلال وبتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا لمساواة الجميع أمام القضاء ، وحماية لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي . يمارس موظفو هيئة كتابة الضبط مهامهم بتجرد ونزاهة واستقامة>> إن الأمن القضائي يحيل إلى دور القضاء بمختلف مكوناته مدنيا دستوريا ، اداريا ، جنائيا وتجاريا ، إلى إقرار الحق وضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية ، وإلى جودة العمل القضائي التي تنطلق من تدبير القضايا والبت فيها، إلى تنفيذها والمساهمة في خلق القاعدة القانونية ، ليس هذا فقط بل يحيل أيضا إلى تلك الشروط والضمانات التي تحيط بالقاضي وهو يؤدي مهامه ،الضمانات التي تحيط بالمتقاضي وهو يبحث عن تحقيق العدالة في قضيته ، فالأمن القضائي كما يرتبط بجودة النص القانوني الضامن للحق ، يرتبط أيضا بالقانون الاجرائي . مفهوم الأمن القضائي يتسع ليشمل محيط القاضي وسلطته التقديرية في البت في القضايا، وقدرته على الاجتهاد تحقيقا للعدالة أحيانا حتى ولم تسعفه النصوص القانونية . في ضوء ما سبق هل سيساهم مشروع قانون التنظيم القضائي في تحقيق الأمن القضائي؟ وبعبارة أخرى وانطلاقا من مشروع قانون التنظيم القضائي ما هي المقتضيات القانونية التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الأمن القضائي ؟ المبحث الأول : الأمن القضائي على المستوى الإجرائي أكد الدستور على أن من المهام الأساسية للقضاء هي حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي ،كما أن الفصل 118 من الدستور المغربي ينص على أن : << حق التقاضي مضمون لكل الشخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون>> وانسجاما مع هذا المقتضى فإن بداية ضمان هذه الأهداف تنطلق من تسهيل الولوج إلى المحاكم وتقريب هذه الأخيرة من المتقاضين ، بالإضافة إلى إحداث محاكم متخصصة كفيلة بالبت بالجودة المطلوبة في مختلف النزاعات . فإلى أي حد تضمن مشروع قانون التنظيم القضائي هذه الاجراءات باعتبارها ضرورية لتحقيق شق مهم من الأمن القضائي . الفقرة الأولى : تسهيل الولوج للمحاكم بقراءة مشروع التنظيم القضائي للمملكة نجد أن مجموعة من المواد تضمن تسهيل الولوج للمحاكم ، والذي لا يقتصر فقط على شبابيك الاستقبال وتحسين الولوجيات بل يمتد مفهوم الولوج إلى المحاكم ليشمل التمكين من الولوج إلى الحق داخل المحكمة. وهكذا نصت المادة 35 من مشروع قانون التنظيم القضائي على أنه :<< يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها ، وتيسير ولوج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لخدماتها ، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها ، وتيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها. يعتبر كل مسؤول قضائي أو من ينيبه عنه ، ناطقا رسميا باسم المحكمة كل فيما يخص مجاله ، ويمكنه عند الاقتضاء ، التواصل مع وسائل الاعلام وتنوير الرأي العام .>> أولا : تسهيل ظروف الاستقبال نظرا لأهمية حقلة التواصل الأولى بين المرتفق والمحكمة فقد نصت المادة 35 على أن يسهر على هذه العملية مسؤولو المحاكم ،ونظرا لأهمية هذه الحلقة فقد عملت وزارة العدل والحريات على بذل جهود على هذا المستوى وخلق برنامج معلوماتي يهم هذه العملية ، غير أنه بدل أن تسهل هذه العملية الولوج إلى المحكمة حصل العكس حيث فرضت بعض المحاكم ولوج المحكمة بالإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف وتسجيلها والاحتفاظ بها وعدم تسليمها للمرتفق إلا عند مغادرته للمحكمة ، وربط الاستقبال بسبب الزيارة والمكتب أو الشخص الذي يرغب في زيارته ، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالتواصل وهو الأمر الذي لم يلاق استحسانا من قبل بعض المرتفقات والمرتفقين لهذا الإجراء خاصة عندما يكون عدد الوافدين كثيرا وتؤدي هذه العملية الى التأخر والانتظار سواء أثناء تقديم البطاقة أو عند تسلمها . وهي أساليب وإن كانت تروم تنظيم المحاكم أو الاستناد إليها في تشخيص وضعية الاستقبال مستقبلا فإننا نعتقد بعدم صلاحيتها على هذه الصيغة . ثانيا : لغة التقاضي والتواصل نصت المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي على أنه : << تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم ، مع العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور. مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يجب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف،كما يحق للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها >> وهكذا يمكن إبداء الملاحظتين التاليتين : إن هذه المقتضيات إيجابية و تعد تفعيلا للفصل الخامس من الدستور الذي ينص على أنه << تظل العربية اللغة الرسمية للدولة . وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها ، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة ، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ،وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية ، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية …>> إن هذه المقتضيات المتعلقة باللغة تضمن حق التقاضي بلغة يفهمها المتقاضي مدعيا أو مدعى عليه ، وتلامس أحد العناصر المكونة لتحقيق الأمن القانوني والأمن القضائي ، وهي خاصية الوضوح : وضوح القاعدة القانونية التي تنظم حقا من جهة ، وتسهيل الوصول إلى